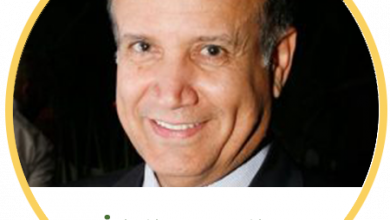النافذة السعودية الأميركية إلى أين؟

وليد فارس
مما لا شك فيه أن هناك نافذة لتحسين العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس بايدن، انتبه لها المراقبون المتخصصون، ويعرف المتابعون في المملكة، والمنطقة، والولايات المتحدة أسباب التغيير في السياسة الأميركية، وأسباب ملاقاة الأولى لهذا التغيير الذي تقدم عليه الأخيرة في التعاطي بينهما. إلا أن السؤال الكبير بشأن هذه المرحلة بالذات. هل “النافذة” فعلاً جدية؟ وهل الطرفان مقتنعين بجدية بعضهما بعضاً؟ وكيف ستتطور نافذة كهذه، وكيف ستتعاطى إيران مع تطور كهذا؟
أسباب التغيير تتضح
في واشنطن باتت أسباب التغيير في سياسة الرئيس بايدن تجاه السعودية تتضح أكثر يوماً بعد آخر. فمن قراءة “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، ومشاهدة “CNN” و”MSNBC”، بات معلوماً أن معسكر الإدارة اتخذ قراراً “باستيعاب الخلافات” مع الرياض، واعتبارها “اختلافات في وجهات النظر” والتركيز على “مرحلة” حالية، حيث واشنطن بحاجة إلى “أصدقائها في المملكة” لمواجهة أزمات عالمية حادة. وبات معروفاً أن الأزمة الأكبر التي تحتاج الإدارة إلى دعم المملكة لمواجهتها هي مسألة إنتاج النفط والغاز في السوق العالمية، مع تصاعد الخلاف الروسي الغربي بسبب حرب أوكرانيا.
“الناتو” يواجه روسيا ويضع عقوبات عليها، وأميركا تشجع أوروبا على مقاطعة الإنتاج الروسي وتعد بروكسل ببديل، وفي الوقت نفسه، الإدارة لا تريد تكثيف الإنتاج الداخلي لهذه المواد. وتأتي الصين لتحاول شراء الغاز الروسي بسعر أرخص. لذا بات على البيت الأبيض أن يجد حلولاً للمعادلة الصعبة. ومن أهم هذه الحلول الحصول على موافقة المملكة والتحالف الذي تقوده لزيادة الإنتاج في الطاقة لمواجهة المعادلة الجديدة. ومعروف أخيراً أن قراراً كهذا ليس سهلاً في واشنطن بسبب الخلاف بين معسكر “أوباما – بايدن” والقيادة السعودية، ولكنه قرار لا بد منه الآن في حسابات الإدارة، أو على الأقل في حسابات الرئيس. أما في السعودية فإن القيادة تتعاطى مع التوجه الجديد لإدارة بايدن موضوعياً، كما تعاطت معها مصر، والإمارات، وإسرائيل. فشركاء واشنطن لهم مصلحة في التقارب مع الولايات المتحدة في كل الظروف، أياً كانت.
خلاف ضمن الإدارة
وكما كتبنا منذ أشهر، فإن الانقسام ضمن الإدارة حول التعاطي مع إيران تعاظم مع الوقت، إذ يقف الطاقم الذي يتفاوض مع طهران حول العودة إلى الاتفاق بعناد خلف نظرية “وقع أولا، رتّب البقي في ما بعد”، ويقف جناح آخر وراء نظرية “أمّن مصلحة الإدارة أولاً، ثم وقّع بعد ذلك”. وتعاظم الشرخ بين الفريقين منذ اندلاع حرب أوكرانيا، وتعاظم أزمة النفط عالمياً، وتصعيد الشروط الإيرانية بالنسبة لأميركا. وانعكس ذلك على المعادلة “السعودية – الأميركية”. فالجناح الضاغط باتجاه توقيع الاتفاق غير متحمس للانفتاح على المملكة، بينما الجناح الذي بدأ يتشدد على النظام الإيراني، بات متحمساً لتقوية العلاقات مع الرياض. ويبدو أن البيت الأبيض بدأ يميل للتقارب مع القيادة السعودية وتحذير إيران من المماطلة في المفاوضات. والسؤال التالي هو: هل التغيير تجاه السعودية جدي؟
كيف تقاس الجديّة؟
في العلوم السياسة مقاييس عدة “لجدية المواقف والقرارات” في العلاقات الدولية، أهمها المصالح المباشرة، وتأثير أصحاب القرار، والمعادلات القائمة. يبدو أن هنالك مصلحة للولايات المتحدة في التقارب مع السعودية، وهي المصلحة البترولية وحاجة الأسواق العالمية حالياً. هذا أمر واضح وحاسم. أما تأثير أصحاب القرار فهو نسبي، يتوزع بين أنصار الاتفاق النووي وأنصار تمتين العلاقات مع التحالف العربي.
الجدير بالذكر أن تقاطع التأثير بين الفريق الذي يدعو للتقارب مع الرياض وكتلة التأثير القريبة من إسرائيل بات بوزن مؤثر في سياسة بايدن تجاه المنطقة، ولكن تأثير كتلة الانفتاح في إيران، وفي مرحلة ما على الإخوان، لا يزال قائماً، مما يعني توازناً مستمراً بين الاثنين سيحسمه الوضع الإقليمي والعالمي في الأشهر المقبلة. أما المعادلات القائمة فتتحكم بها حرب أوكرانيا من ناحية، والمواجهة الإسرائيلية-الإيرانية في المنطقة من أخرى.
ثقة متبادلة؟
هل هنالك قناعة لدى الطرفين بجدية القيادتين حول الانخراط بعلاقة جديدة تتخطى الماضي، أي سنوات “أوباما – بايدن”. بعبارة أخرى هل هنالك ثقة بين الإدارة والمملكة حول المصلحة المشتركة ووفاء الحكومتين بوعودهما المتبادلة؟ الجواب الأول هو أن التغيير في رؤية الإدارة لا يزال حديث العهد ويصعب الحكم عليه في فترة قصيرة. ولكن من ناحية أخرى لا شك أنه لكل فريق مصلحة أكيدة بالتقارب، ولكن بحذر شديد وخطوة خطوة، بسبب التوازنات الدقيقة داخل واشنطن، ليس فقط ضمن الإدارة، ولكن أيضاً مع المعارضة.
كيف ستتطور النافذة؟
الخطوات ستتلاحق من زيارات أميركية للرياض، وزيارات وفود سعودية لواشنطن، بهدف دراسة ما يمكن أن يتحول إلى خطة مرحلية تأتي لمصلحة الطرفين. الإدارة ستعد السعودية بالدفاع عن أراضيها ودولتها، والمملكة ستدرس سبل مساعدة الولايات المتحدة لحل بعض المشكلات على صعيد الاقتصاد العالمي.
إن العلاقات القديمة بين البلدين التي بدأت قبل الحرب الباردة واستمرت بعدها، بإمكانها أن تستوعب الاختلافات في وجهات النظر وإقرار خطط مشتركة لحل مواضيع محددة، وإن تعثرت العلاقات أحياناً، كما حصل بين حلفاء “الناتو”، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا خلال حرب العراق في 2003. إلا أن الملف الذي سيحسم نجاح العلاقة الجديدة بين إدارة بايدن والقيادة السعودية سيكون دون شك الملف الإيراني، بما فيه مسألة الاتفاق النووي. والسؤال هنا بشأن تحرك طهران إزاء محاولة بايدن التقرب من السعودية.
رد فعل إيران
بالطبع النظام الإيراني ليس له مصلحة في عودة العلاقات الخاصة بين الرياض وواشنطن. بل إن اللوبي الإيراني كان من بين القوى الرئيسة التي تقف وراء توتير العلاقات بين أميركا والسعودية.، وقد لعب دوراً كبيراً في تعبئة الرأي العام الأميركي ضد القيادة السعودية لسنوات طويلة. فكيف ستتصرف إيران إزاء التقارب الحاصل الآن؟ أولاً ستستعمل نفوذ لوبي “الاتفاق النووي” لتحاول إفشال التقارب بين واشنطن والرياض. ثانياً ستحاول دغدغة المفاوضين الأميركيين بأن التوقيع ممكن، “ولكن دعم السعودية قد يفشل الإنجاز”. ثالثاً قد تهدد إنتاج الطاقة الخليجي من جديد. كل الوسائل ممكنة.
مصير النافذة
ولكن مصير “نافذة التقارب” الأميركي-السعودي يبقى داخل واشنطن وساحاتها السياسية، وليس في المنطقة. هذا المصير سيقرر داخل الإدارة بين أنصار مشروع أوباما للشراكة مع إيران و”الإسلامويين” الذي انطلق في 2009، ويسعى البعض إلى تنفيذه من ضمن الإدارة، وبين كتل المصالح الكبرى التي تحسب ما بين الاقتصاد، والأمن، والسياسة. في أول عام لبايدن، نجحت “مدرسة أوباما” في قيادة السياسة الخارجية، ودفعت بالاتفاق الإيراني على حساب الشراكة مع المملكة والتحالف. أما منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2022، وبسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتحت الضغط الغربي والعالمي، يتحرك البراغماتيون في الإدارة لإعادة العلاقة مع المملكة والتحالف بهدف عدم خسارة شركاء أساسيين وضروريين في المنطقة. ونظراً للأوضاع الداخلية الأميركية، أمام الإدارة حوالى خمسة أشهر لتدعيم الجسور مع الرياض، قبل الانتخابات النصفية، واحتمال عودة الأكثرية الجمهورية في الكونغرس، ونتائج عودة كهذه، إن حدثت، على السياسة الخارجية. إنها نافذة بالفعل، إما أن تكبر، وإما أن تُغلق.